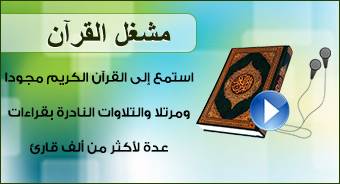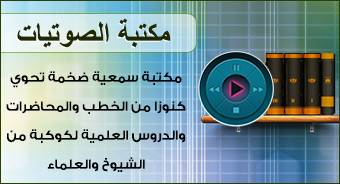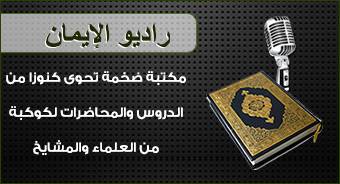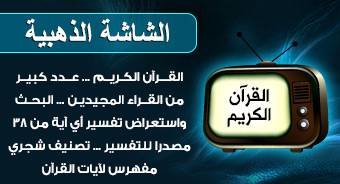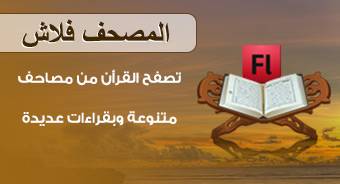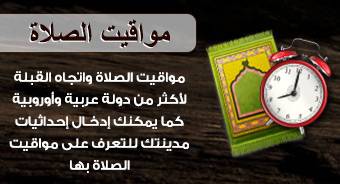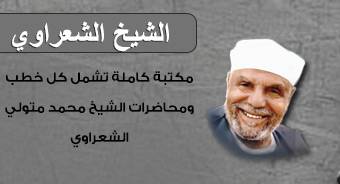|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
أي عبدك يا سيدي طال بحاجة، فهي تستعمل في معان مترابطة؛ لأننا قلنا: ولي تعني القريب، فإذا كان العبد في حاجة إلى شيء فمن أول من ينصره؟ سيده، وإذا نادى السيد، فمن أول مجيب له؟ إنه خادمه، إذن فيطلق على السيد ويطلق على العبد، ويطلق على الوالي، {الله ولي الذين آمنوا}. وقوله الحق: {الذين آمنوا} يعني جماعة فيها أفراد كثيرة، كأنه يريد من الذين آمنوا أن يجعلوا إيمانهم شيئا واحدًا، وليسوا متعددين، أو أن ولاية الله لكل فرد على حدة تكون ولاية لجميع المؤمنين، وماداموا مؤمنين فلا تضارب في الولايات؛ لأنهم كلهم صادرون وفاعلون عن إيمان واحد، ومنهج واحد، وعن قول واحد، وعن فعل واحد، وعن حركة واحدة.وكيف يكون {الله ولي الذين آمنوا}؟ إنه وليهم أي ناصرهم. ومحبهم ومجيبهم ومعينهم، هو وليهم بما أوضح لهم من الأدلة أو أنه لفتنا إلى الأدلة؟ وتلك هي ولاية من ولايات الله. فقبل أن نؤمن أوجد لنا الأدلة، وعندما آمنا والانا بالمعونة، وإن حاربنا خصومنا يكن معنا، وبعد ذلك تستمر الولاية إلى أن يعطينا الجزاء الأوفى في الآخرة، إذن فهو ولي في كل المراحل، بالأدلة قبل الإيمان ولي. ومع الإيمان استصحابًا يكون ناصرنا على خصومنا وخصومه. وفي الآخرة هو ولينا بالمحبة والعطاء ويعطينا عطاء غير محدود، إذن فولايته لا تنتهي.{الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور} إنه سبحانه يخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان؛ لأن الظلمات عادة تنطمس فيها المرائي، فلا يمكن أن ترى شيئا إلا إذا كان هناك ضوء يبعث لك من المرئي أي أشعة تصل إليك، فإن كانت هناك ظلمة فمعنى ذلك أنه لا يأتي من الأشياء أشعة فلا تراها، وعندما يأتي النور فأنت تستبين الأشياء، هذه في الأمور المحسة؛ وكذلك في مسائل القيم، {يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات}.هل هم دخلوا النور يا ربنا؟ لنا أن نفهم أن المقصود هنا هم المرتدون الذين وسوس لهم الشيطان فأدخلهم في ظلمات الكفر بعد أن كانوا مؤمنين، أو {يخرجونهم من النور إلى الظلمات}، أي يحولون بينهم وبين النور فيمنعونهم من الإيمان كما يقول واحد: أما دريت أن أبي أخرجني من ميراثه؟ إن معنى ذلك أنه كان له الحق في التوريث، وأخرجه والده من الميراث. وهذا ينطبق على الذين تركوا الإيمان، وفضلوا الظلمات. والقرآن يوضح أمر الخروج من الظلمة إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان في مواقع أخرى، كقول سيدنا يوسف للشابين اللذين كانا معه في السجن: {وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانَ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (36) قَالَ لاَ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلاَّ نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (37)} سورة يوسف.فهل كان سيدنا يوسف في ملة القوم الكافرين ثم تركها؟ لا، إنه لم يدخل أساسًا إلى ملة القوم الذين لا يؤمنون بالله. إن هذه الملة كانت أمامه، لكنه تركها ورفض الدخول فيها وتمسك بملة إبراهيم عليه السلام. وفي التعبير ما فيه من تأكيد حرية الاختيار. وهناك آية أخرى يقول فيها الحق: {وَاللّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (70)} سورة النحل.إن معنى الآية أن الله قد خلقنا جميعا، وقدر لكل منا أجلًا، فمنا من يموت صغيرًا، ومنا من يبلغ أرذل العمر، فيعود إلى الضعف وتقل خلايا نشاطه فلا يعلم ما كان يعلمه. وليس معنى الآية أن الإنسان يوجد في أرذل العمر ثم يرد إلى الطفولة. وعندما يقول الحق: {والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات} فالحق أورد هنا كلمة أولياء عن الطاغوت، لأن الطاغوت كما قلنا: ألوان متعددة، الشيطان طاغوت، والدجال طاغوت، والساحر طاغوت. وجاء الحق بالخبر مفردًا وهو الطاغوت لمبتدأ جمع وهو أولياء، ووصف هؤلاء الأولياء للطاغوت بأنهم يخرجون الذين كفروا من النور إلى الظلمات.لقد أفرد الله الطاغوت وأورد بالجمع الأفراد الذين ينقلهم الطاغوت إلى الظلمات. ولماذا لم يقل الله هنا: طواغيت بدلا من طاغوت؟ إن الطاغوت كلمة تتم معاملتها هنا كما نقول: فلان عدل أو الرجلان عدل أو الرجال عدل. وعلى هذا القياس جاءت كلمة طاغوت، فالشيطان والدجال والكاهن والساحر والحاكم بغير أمر الله؛ كلهم طاغوت، لقد التزمت الآية بالإفراد والتذكير. فالطاغوت تطلق على الواحد أو الاثنين أو الجماعة، أي أن المخرجين من النور إلى الظلمات هم أولياء الطاغوت، أو من اتخذوا الطواغيت أولياء، وهم إلى النار خالدون. والدخول للنار يكون للطواغيت ويكون لأتباع الطواغيت، كما يقول الحق في كتابه: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (98)} سورة الأنبياء.إن أتباع الطواغيت، والطواغيت في نار جهنم. وقانا الله وإياكم عذابها. ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا صورة واقعية في الكون من قوله: {الله ولي الذين آمنوا}، فهو الولي، وهو الناصر. اهـ.
ومنه يقال داري تلي دارها، أي: تقرب منها ومنه يُقالُ للمحبّ المقارب ولي؛ لأَنَّهُ يقرب منك بالمحبَّةِ والنُّصرة، ولا يفارقك، ومنه الوالي؛ لأَنَّه يلي القوم بالتَّدبير والأمر والنّهي، ومنه المولى، ومن ثمّ قالوا في خلاف الولاية: العداوة من عدا الشَّيء: إذا جاوزه، فلأجل هذا كانت العَدَاوةُ خلاف الوِلاَية ومعنى قوله تبارك وتعالى: {الله وَلِيُّ الذين آمَنُواْ}، أي: ناصرهم ومعينهم، وقيل: مُحبهم.وقيل: متولي أمورهم لا يكلهم إلى غيره.وقال الحسنُ: ولي هدايتهم.قوله: {يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظلمات إِلَى النور}، أي: من الكُفْرِ إلى الإيمان.قال الواقدي: كلّ ما في القرآن من الظُلُماتِ، والنور فالمرادُ منه: الكفر والإيمان غير التي في سورة الأنعام {وَجَعَلَ الظلمات والنور} [الأنعام: 1] فالمراد منه اللَّيل والنَّهار، سُمي الكفر ظُلمة لالتباس طريقه، وسُمي الإسلام نُورًا، لوضوح طريقه.وقال أَبو العبَّاس المُقرئ الظُّلُمَات على خمسة أوجه:الأول: الظُّلُمَاتُ الكفر كهذه الآية الكريمة.الثاني: ظُلمة اللَّيلِ قال تعالى: {وَجَعَلَ الظلمات والنور} يعني اللَّيل والنهار.الثالث: الظُّلُمَات ظلمات البر والبحر والأهوال قال تعالى: {قُلْ مَن يُنَجِّيكُمْ مِّن ظُلُمَاتِ البر والبحر} [الأنعام: 63] أي من أهوالهما.الرابع: الظُّلُمَات بطون الأُمَّهات، قال تعالى: {فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاَثٍ} [الزمر: 6] يعني المشيمة والرحم والبطن.الخامس: بطنُ الحُوتِ قال تعالى: {فنادى فِي الظلمات} [الأنبياء: 87] أي في بطنِ الحوت.قوله تعالى: {والذين كفروا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطاغوت}: {الذين} مبتدأ أولُ، وَأَوْلياؤهم مبتدأ ثانٍ، وَالطَّاغُوتُ: خبرهُ، والجملةُ خبرُ الأَوَّلِ. وقرأ الحسنُ {الطَّوَاغيت} بالجمع، وإن كان أصلُه مصدرًا؛ لأنه لمَّا أطلق على المعبود مِنْ دُونِ الله اختلفَت أنواعهُ، ويؤيِّد ذلك عَوْدُ الضميرِ مَجْمُوعًا من قوله: {يُخْرِجونهم}.قوله: {يُخْرِجونهم} هذه الجُملة وما قبلها من قوله: {يُخْرِجُهم} الأحسنُ ألاَّ يكونَ لها محلٌّ من الإِعرابِ، لأَنَّهُمَا خَرَجا مخرجَ التفسير للولاية، ويجوزُ أن يكونَ {يُخْرِجُهم} خبرًا ثانيًا لقوله: {الله} وَأَنْ يكونَ حالًا من الضَّمير في {وليُّ}، وكذلك {يُخْرِجُونَهُم} والعاملُ في الحالِ ما في معنى الطَّاغُوتِ، وهذا نظيرُ ما قاله الفارسيُّ في قوله تعالى: {نَزَّاعَةً للشوى} [المعارج: 16] إنها حالٌ العاملُ فيها {لَظَى} وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى ومَنْ وإلى مُتعلِّقان بفعلي الإِخراج. اهـ. بتصرف.
|